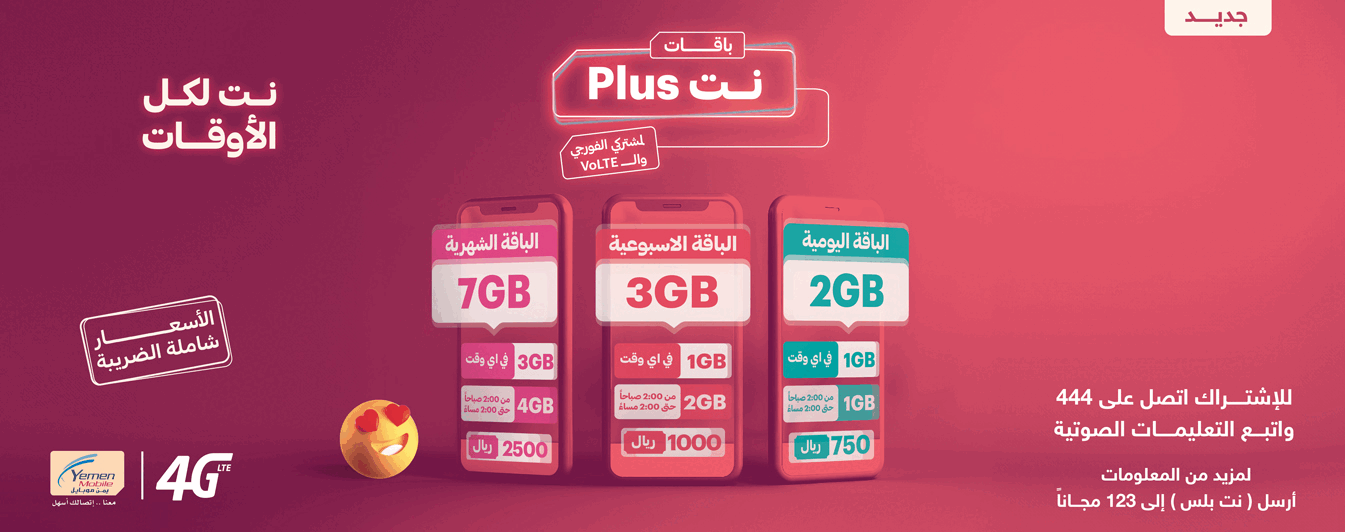لابد للإنسان أن يتشكل في صميم الحرية،
لأنها قدره المبتهج: «فالوضع الطبيعي للإنسانية يكمن في اشتياقها للوجود في مملكة الحرية»، وبلغة سارتر المتهكمة: «إنني غير موجود، مادام أن وجودي يكون دائما رهينة التشويق في الحرية، أنا مشروع وجود، رغبة في الوجود». ربما تكون هذه اليقظة الانطولوجية التي تتوجه إلى المستقبل، تبحث في الماضي عن ماهيتي، وفي المستقبل عن تطوير هذه الماهية، ولن يتم ذلك للإنسان الذي يجهل حقيقته، بل للإنسان الذي اكتشف قارة الوعي الذاتي، وهي أمتع قارة ينبغي اكتشافها، فبدون اكتشافها تظل الروح مثل الطفل الذي يحتمي بأمه: «فهناك طفرة كيفية عندما يولد الطفل ويرى النور، فكذلك الروح التي تشكل نفسها ببطء وبهدوء لتتخذ شكلها الجديد.. إذ تظل الروح تنمو وتتفتت في العالم القديم قطعة قطعة إلى توقظه تماما متخذة شكلها الجديد حتى تشهد فجأة بزوغ النهار الذي يضيء بومضة واحدة ملامح عالم جديد».
في إمكان هيغل أن يتهكم من الحس المشترك الذي يكون قانعا بعصره، يقضي حياته بثياب النوم، ولا يرى في العالم سوى اللذة الحسية، أما الحرية، فإنه يدير ظهره إليها، لأنه محروم من الفكر، والحرية من طبيعتها لا تظهر إلا عندما يظهر الفكر، الذي يرعبه الوعي الشقي، لأنه في ظل هذا التفاعل بين الحرية والفكر يولد العصر الجديد، إنه عصر التنوير، بيد أن غياب الفكر والحرية عندنا قد فرض علينا العيش في عتمات القرون الوسطى، حيث جهالة الأمة والجيوش المنظمة والبؤس السياسي علامات على موت هذه الأمة رمزيا. فبأي معنى يمكن الحديث عن الحرية ونحن نعلن عن موت الفكر؟، فمن قام باغتيال الفكر؟، هل هو نفسه من اغتصب الحرية؟، وإلى متى يظل هذا النداء بدون منادى؟، وما معنى الدفاع عن الفلسفة النقدية في مجتمع ميت؟.
من الصعب إعادة الحرية من الذين اغتصبوها دون بناء منارة الفلسفة النقدية التي تسعى إلى إيقاظ الإدراك من التخدير، وبخاصة أن النفوس الضعيفة ترضخ بسرعة إلى هذا التخدير، الذي تمارسه السلطة الدينية بعنف. وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية وجهان لعملة واحدة. هكذا يتم زرع هوة عميقة بين الإنسان والوعي الذاتي، بين الشعب والإرادة العامة، ويتم حرمانه من الحق في المساواة والحرية، لأنه لا يعرف حقوقه السياسية، بل إنه يقوم بواجباته الدينية ويؤدي الضرائب، ويشقى في الحقول والمعامل، بيد أن الحقيقة تظهر حين يحل عصرها، ولعل هذا العصر لن يكون سوى عصر التنوير، حيث سيستيقظ العقل من سباته الدوغمائي، الذي دام كل هذه القرون.
تلك هي رسالة الفلسفة التي يتم اضطهادها بتهم كاذبة، مثل الجنون الإلحاد، والعصيان والثورية. والحال أن الفلسفة لخطيرة عندما تهمش، لأنها تهدد مصالح هؤلاء السفلة الماكرين والمتآمرين، ومع ذلك فإن الحرية تعلمني أن أقاتل وأقاتل من أجلها، لأنني طفل على حضنها الحلو أنمو وأكبر، لأنها تشيد إرادتي، بدونها ستظل هذه الإرادة فارغة من المعنى، حمقاء، تائهة في عوالم الشهوات لا هدف لها. ترتبط بالصمت، وبالكلمات التي لا لغة لها، وبتلك الهمسات المعاندة، منهارة غير قادرة على الحوار مع ذاتها، ذلك أن الروح تكون مهزومة كجذور محروقة لشجرة الوجود: «ومصيبة المجانين، تلك المصيبة اللامتناهية لصمتهم، تتمثل في كون أفضل المتحدثين باسمهم هم الذين يخونونهم أكثر». بل إنهم مجانين بالسلطة والثروة، وحتى لا أحرمكم من التمتع بجماليات هذه التأملات الفلسفية ينبغي أن نتساءل، هل بإمكاننا استدعاء ديكارت أو فوكو لتعرية هذا الجنون الصامت؟ ألا يكون هذا الفصل عن الحرية قدحكم علينا بالتيه الأبدي؟، وما معنى هذا الصمت المندهش من ذاته؟، وما علاقة غياب الحرية بحضور الجنون؟.
كم هي ملهمة هذه الغرابة التي أضحت تضيف علينا الخناق، وتحولت إلى قدر حزين يفرض الصمت حتى في النوم. فإذا كانت الحرية التي تناضل من أجل الإنسان: «لأنها تمتلكه قبل أن يمتلكها مادامت مجرد سماح للموجود بالوجود حسب هايدغر، فإن الإنسان الذي يهرب منها يولد بدون النور الفطري، ويقضي كل حياته على هوامش المقابر، وإلا كيف يمكن تفسير هذا الهروب من أوفر الأشياء حظا من البراءة؟، وبأي معنى تكون حياة الإنسان منفعلة مع العدم وليس مع الوجود؟، وبعبارة واضحة؛ ألا تكون الحرية هي مقياس السعادة والشقاء في الأرض؟، وهل كان من المفروض أن نعيش كل هذا الاستبداد لكي نتعرف على الحرية؟. لقد توقفت عن الوجود، عندما أصبحت مجرد مكتبة، بهذه العبارة يضعنا سارتر في قلب ما ينتظرنا، في ذلك الأمل المعلق في السماء بيد أن الحرية توجد بين الأرض والسماء، ترافق شروق الشمس على الأمم المتحضرة، وتختفي مع غروبها عند الأمم المنحطة، فلا يمكن استيراد الحرية، لأنه من المستحيل تصديرها إلى تلك الشعوب التي حرمت منها، وبخاصة وأنها تؤسس القوانين على الدين، والدولة تتحول إلى عقيدة، بدلا من حكم الناس بالحرية، تستعبدهم باسم الدين، حيث تتدخل في تسيير المساجد وفرض الخطب، وتحويل رمضان إلى مصحة للتخدير، وجعل الشعب مجرد قطيع في يد الحاكم، هكذا يصبح الكلام عن الحرية كفر، والمدافع عنها كافر، لكن هوية هذه التهمة تظل وسطوية، لا تستند على القوانين المدنية، التي تخضع للحقوق والواجبات، وأهم حق الوجود الفردي، والاختلاف الفكري والثقافي في إطار الميثاق الاجتماعي، الذي يجعل من المصلحة العامة مشتركا بين الشعب، وهذه المصلحة لا تقوم في غياب الحرية والمساواة، باعتبارهما عماد السلطة السيادية، وهي: «واحدة، في رأي روسو، لا تتجرأ وهي ملك للشعب الذي لا سيادة لأحد سواه». ولذلك فإن الحكومة تدين بوجودها للشعب، وينبغي أن تحكم بالقوانين المدنية وتحترم الدستور، وإلا ستصبح متعصبة للإرادة العامة. والحق أن النظام الديمقراطي، يجب أن يستند إلى مقدمات عقلانية، ومبادئ سياسية مدنية، بدلا من مقدمات كلامية وتيولوجية تسعى إلى تحصين الشريعة والدفاع عنها ضد المخالفين لها في الرأي، كما كان سائدا عند الأشاعرة، الذين أعلنوا الحرب على الجميع، أي على كل ما ليس أشعريا، والغريب أن هذه الحرب أضحت أبدية. بيد أن المجتمع الحديث في غنى عن هذه الحرب، ذلك أن الشعب في رأي الفلسفة السياسية، يشكل جسما سياسيا واحدا تحركه إرادة واحدة، على الرغم من المصالح الخاصة. لا نريد حكومة تقدم لشعب هبة الحرية المسمومة كيما تشرع للعبودية، باسم السلطة الروحية: «فالعبودية مستمرة عندنا، ولكن تحت اسم ملطف». وبلغة روسو: «إن قيودها المنسوجة من مادة واحدة لا تختلف إلا من حيث اللون. هنا تكون سوداء، وتبدو ثقيلة، وهناك تبدو أقل كآبة، وأخف وزنا، لكن لو وزنتهما بتجرد، فلن تجد بينهما أي تفاوت، فكلاهما من صنع الضرورة». ففي ظل نظام العبودية يكون السيد معنيا بالسهر على حياة العبد، بل إن مصير الجياد بالذات لأحسن من مصير العمال الأجراء. فالسخرية من هذه الحرية الوهمية، وهذه العبودية الواقعية، فلا أحد سيمح لكم بالكلام عن حرية العامل، والحاجة ترغمه على الرضوخ للشروط التي يمليها عليه الرأسمالي المستغل: تقولون إنه حر! تلك هي مصيبته، فهو ليس لأحد: ولكن ما من أحد له أيضا. والحال أن مقولة الشعب يريد الحرية، لا يمكن تفسيرها تفسيرا مغلوطا، لتأخذ معنى مغايرا لحقيقتها، وكأنها ثورة على خليفة الله في الأرض، فيصبح الصراع صراعا إيديولوجيا وليس صراعا مدنيا، ومن السخافة أن يمتلك شخص واحد السلطة السيادية التي تمنحه الحق في الموت والحياة. ولذلك فإن أول ما يجب القيام هو إعادة السيادة للشعب، هذا الذي من المفروض أن يتمتع بالحرية والمساواة، لأنهما هبة من الطبيعة، وليس من شخص معين، فالحق في الحرية هو نفسه الحق في الوجود، وليسقط الظلم، والعبودية، والطغيان. ولتحيا الحرية. ذلك أن التنوير ينفلت، ولا يمكن ترميمه.
إضافة تعليق